 ليست الحياة الحزبية و في دائرتها التعاطي السياسي بالأمرين الجديدين علينا. كلا، فلقد تأسست أولى الأحزاب قبل الاستقلال، و تنوعت منطلقاتها و تباينت خطاباتها و فلسفاتها و توجهاتها حتى عبرت آنذاك عن ما كان حاصلا من الاختلاف
ليست الحياة الحزبية و في دائرتها التعاطي السياسي بالأمرين الجديدين علينا. كلا، فلقد تأسست أولى الأحزاب قبل الاستقلال، و تنوعت منطلقاتها و تباينت خطاباتها و فلسفاتها و توجهاتها حتى عبرت آنذاك عن ما كان حاصلا من الاختلاف
في الرؤى و الأساليب بين الفرقاء و ما كان يرتسم في الآفاق من المطالبات بالتحلل من بعض الاعتبارات الاجتماعية السلبية و ما يؤطر لها من واقع مادي مناف للرسالة الجديدة و ما تتضمنه من أساسيات الدولة المركزية الحديثة التي أخذت معالمها ترتسم بـ”فضل” الاستعمار و إن يندرج أمر اعتبار هذا الفضل في سياق إشكالية الاستعمار بين الرفض القطعي له و ما سرعه الأخير و منذ أولى لحظات مقدمه – على الرغم من كل الأطروحات، حلوها و مرها – في جديد التعاطي مع الكثير من الأوجه السلبية للنظام الاجتماعي و التي كانت مخالفة في الصميم لروح و جوهر الدين الحنيف حتى.
و قد ظلت هذه الأحزاب تملأ بوجودها على ذلك النحو الساحة السياسية دون أن تحدث في واقع الأمر ثورة تذكر في العقليات العصية و لا أن تؤصل لنهج تسير عليه و تسير به الدولة إلى الأمام. و لما كان الاستقلال و الإعلان عنه تراجع أداء تلك الأحزاب و هيمن محلها الحزب الواحد الذي قدر له أن لم يجد نضجا كافيا يقاومه حتى في الحركات التي حاولت مناهضته و احتواها واحدة تلو الأخرى لظل يسير الحياة السياسية و الدولة معا بمزاجه حتى تدخل العسكر في العام 1978 فأدخل البلاد في دوامة جديدة من تعاقب القيادات العسكرية التي كانت تستند عشوائيا على مفاهيم أيديولوجية متباينة اعتمدت في فوضوية أحوالها على استخدام الممارسات الحزبية تارة و أساليب الحركات الايديولوجية تارة أخرى.
و ليست الحياة النقابية و لا حركية منظمات المجتمع المدني بغريبة هي الأخرى على البلاد، فإن تاريخ وجودها بعمر الدولة الحديثة حيث رأت أوائلها النور أيام التأسيس في بداية الستينات من القرن الماضي و قد ملأت الفراغ الذي كان قائما في ظل غيابها. وها هي اليوم تضاهي في عددها الأحزاب التي زادت عن الستين، و قد تنوعت مشاربها و مجالاتها و أهدافها و أساليبها و خطاباتها و أدواتها و مناهجها. و هذه النقابات التي ليست بأقل حظا في الحضور و الديناميكية حتى باتت تنافس في كل ناد و تقيم من المناسبات ما لا حصر له و تتحدث بكل لغات النضال و المطالبات الحقوقية و تطرق كل أبواب التمويلات و الاستثمار.
و مع ذلك فلم تحقق أي من الأحزاب على وفرتها و لا النقابات على اختلاف مشاربها و لا منظمات المجتمع المدني على انتشارها كالجرب في جسم الكيان أي مكسب للشعب بمختلف فئاته و لم تلامس أيا من الهموم و الطموحات التي تعتلج في نفوس أفرادها و لا، ما يراود عقولهم أو تجيش به صدورهم.
تلك هي الحقيقة المقيتة التي لا تغيب مع ذلك دواعيها الحقيقية عن أي ذهن ثاقب و تبدو ماثلة بوضوح للعيان دامغة بكل تفاصيلها للأذهان صارخة بحقيقتها اللاذعة و طعمها المر.. لا يضاهيها في بروزها الطافح سوى ما يكون من أسبابها حالة استثنائية من كل حالات العالم الاجتماعية و وضعياته السياسية و النقابية و أوجه مجتمعاته المدنية. و إن أول هذه الأسباب مجتمعة لكامن مطلقا في غياب البعد الوطني – شعورا و وجدانا و لصيقا بالذاتية بما تتضمنه تلك الحالة و ذلك البعد من موجبات قدسيته ـ عن مقاصد الأحزاب و النقابات و منظمات المجتمع المدني النبيلة في أساسها، الأمر الذي ينحصر أيضا معه كل عمل هذه الأطر سلبيا في النرجسية المزمنة لمؤسسيها و المتعاطين أنشطها و ما يترتب عنه ذلك من مضاعفات أمراض القلوب التي أقلها الحسد و الحقد و الغل و الرياء و الغدر و النفاق و الكراهية و المكر و الغضب و العداوة لا سيما و أن الخلفية كلها رهينة اعتبارات و ممارسات موغلة في الماضي متقمصة أدهى و أمر ما تكون به الإساءة إلى روح الإسلام الحنيف و تعاليمه الإنسانية الموحدة و البناءة السمحاء.
إن أرضية الممارسة السياسية بمفهومها العام، في قاموسنا المتداول و الذي يشمل، دون وجود لأية حدود أو قيود أو ضوابط، العمل النقابي و الحقوقي و المدني و الديني حتى، أشبه ما تكون بقطعة الشطرنج بملوكها و ملكاتها و قلاعها و فرسانها و بيادقها. و إن اللاعبين منا – بعكس ملوك الهند و الفرس الذين ابتكروها في غابر الأزمان ليضعوا بها إمعانا في الحفاظ على نفوس رعيهم أوزار حروب حقيقية دامية و مجمرة – ليؤلبون بها المواجع بـ “سادية” لا تسمي نفسها فينكؤون بأنصال خناجرها الجراح و يحرقون بعضهم طمعا في أن يصبح رمادا غير عابئين بما يترتب عن ذلك العمل المختل من الأضرار البالغة في حق البلد و توازنه و ثقافة أهله و في أسلوب تعاطيهم مع دينهم الحنيف و في قيام حاضرهم و بناء مستقبلهم.
و مهما تكن التقلبات كثيرة و متشعبة في الشأن السياسي لأي بلد فإن اللجوء إلى الحوار سيبقى بمفرده أهم ملامح هذه التقلبات و الوجه الأبرز من أوجه التحضر في الممارسة بوصفه الأكثر أهمية في حياة الأمم و مسيرتها ضمن الحيز الذي يضمنه لها من الأمن و الاستقرار.
صحيح أن مثل هذا الكلام لا يحمل مع ضعف الاستماع إليه على محمل الجد و أنه نفخ في الرماد أو الكلام لمن لا أذن له. و لكن صحيح بالمقابل أن هذا الجد المطلوب للاستماع إليه حتى يحمل عليه في هذا الظرف الدقيق هو بالنتيجة أولى ضحايا ذات وضعية هي في الصميم شكلت أسلوبا اجتماعيا بل و دستورا مجتمعيا سلبيا استطاع أن يتبلور و يصمد من دون الجد و ممنوع أن تغير فيه السنون أو تؤثر فيه التحولات المتلاحقة من حوله مهما يكن و مهما تطلبت الظروف ذلك.
و المتتبع لأهم الأزمات التي تميز المشهد السياسي لا بد أن يدرك دون كبير عناء أنها تفتقد عمدا إلى الجد المطلوب لحلحلتها علما بأن ذلك لا يخدم أجندة أي من الأطراف و البلاد على أعتاب انتخابات رئاسية ستحدد اتجاه البلد و مصيره خلال عهدة الخمس سنوات القادمة. و هي المعركة التي يستخدم فيها السياسيون و أحزابهم كل أسلحتهم حتى يقطعوا الطريق على خصومهم و يقيضوا كل جهودهم و لو كانت إيجابية تخدم الشعب و تقوى أركان الدولة… أسلحة منحوتة هياكلها من عقليات متخلفة و مركبة على منوال التركيبة النفسية لعصور ولت و إيقاع أعبارات لا تلائم منطق الظرف بدون حتى الأخذ بما كان لهذه العصور من محاسن… و هي مع ذلك الاعتبارات التي يلمعها الجميع و يُكسيها بكل جرأة أثواب قيم الإنصاف السياسي و المفاهيم الديمقراطية و تبني الحوارية ثم يشهرها على العكس من كل ذلك سيفا بتارا في وجه الواقع المثخن بجراحات التخلف المزمن و الأمية المدمرة و كأنما يصدق فينا “الأخذ من الجبل خشونة حجارته و ترك علوه و ظله”.
و لا يتعلق الأمر في هذا الوجه فقط بالسياسة و شِعبها، و إنما ينسحب بكل تجلياته كذلك على الدين الحنيف و المنظومة الأخلاقية المنبثقة عنه بما تنظر له من سلوك فاضل و عمل ينسجم مع تعاليم الإسلام النيرة، الأمر الذي خلق عند الشعب في ذهنيته و ممارساته نوعا من الذهول و الارتباك جعلاه يلامس حد الانفصام عن قاطرة السياسة بكل التوجهات فيها.
و ليس الذي تشهده العاصمة من تجاوزات خطيرة باتجاه المعتقد سوى تعبيرا متقدما عن هذه الوضعية أكثر من كونه نوايا ناضجة موجهة في الصميم للإضرار بالبعد الديني الذي هو دون شك أو جدال الخلفية المشتركة لكل المواطنين على اختلاف أعراقهم و شرائحهم، اللهم ما يكون فعلا من محاولة بعض التنظيمات الدولية المعادية للإسلام استغلال ذلك لصب النار على الزيت سبيلا إلى تحقيق مآربهم الدنيئة و المحدة الأهداف و إن خص كل قطر بشكل من أشكال المساس بالدين.
و في ظل هذا الانفصام المُغَيب على حضوره الصارخ، الذي تعانيه على حد سواء الشخصية السياسية و الفرد داخل النخبة “المستقيلة عن دورها”، لا بد من الوقوف طويلا عند الأسباب القادمة في أغلب ملامحها من العقلية المتحجرة و لا بد من التأمل مليا في مضاعفاتها الماثلة بقوة والمتلاحقة بسرعة حتى يقيض الله للأمر من يأخذه على محمل الجد فيعكف على تحويل مجراه الجارف إلى وجهة سده و تطويعه لخير قابل الأيام و قادم الأجيال.
و ليست هذه المهمة من الصعوبة إلا بما هو واقع من تقاعس هذه النخب عن أدوارها و تغافلها عن ما سيلحق بها إن عاجلا أم آجلا من المنقلبات الخطيرة إن ظلت تنهج نفس السبل و تمارس أنشطتها الانفرادية و افتعال الغياب التام للأفق الشمولي بنفس الأدوات الحادة الشفرة و التركيبة المسممة.
هي الحقائق المزعجة و إن طمرت تحت وابل من الدعائية و مظاهر براقة تحاكي في الشكل ما يدور من حولنا دون تأسيس، بأي مستوى كان، لجوهرية تعد المستقبل بعدما تكيف الحاضر مع متطلبات المرحلة.
لا الإعلام ورقيا و مسموعا و مرئيا و رقميا – و الذي هو على ضعفه المزمن – بـ”انتقائية” أغلبه المحبطة و “تلميعيته” المفضوحة و “إقصائيته” الخادشة و “تحريضه” المتعمد بغير وجه حق و لا مراعاة لتوازنات البلد الهشة أصلا، يساعد على ولوج هذا التوجه الجديد أو يمهد لتعرية كل الأساليب المخالفة للخيار الديمقراطي الذي يعلن الكل عن تبنيه و الأخذ بمنهجه.
و إنه بغياب هذا الدور الأساسي للإعلام – الذي ما كان إلا يكسب، إن هو اضطلع بمهمته على الوجه الصحيح، البلد مناعة ضد وباء التمزق و التفكك – تزيد الحالة النفسية لدى كل النخب قتامة و يتعرض الوطن أكثر للارتجالية السياسية و النقابية و عند المجتمع المدني و الوصولية و سطوة “البارونات” و حواشيهم على روح الكيان و مقدراته و و هم الذين لم تفرز على الأرجح أغلبيتهَم الغيرةُ على الوطن و لم تؤرقهم في الصميم اهتمامات ساكنته و احتياجاتها الملحة إلى الأمن و التوافق و العدل و العمل التنموي الشامل بتوجيه ما يحويه البلد من مقدرات لذلك و كسب رهانه.
و إنه ما لم يتم التأسيس و بسرعة لوعي سياسي جديد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى و مطلق نهائيا لكل الاعتبارات ذات العلاقة بالماضي القبلي و الإقطاعي و الطبقي و التقسيم الاثني، فإن السياسة ستظل بكامل طيفها عبارة عن محميات مملوكة لأشخاص أو في أحسن الأحوال لجهات متدثرة بمفاهيم تخلق حولها بعض الألق فتصيب به بعض الذي تريد في دائرة لا تسع الوطن، لا تقتسم الثمار و لا تقي من عواقب الشطط و غوائل الزمن.
أخبار عاجلة
جميع الحقوق محفوظة لموقع المرآة
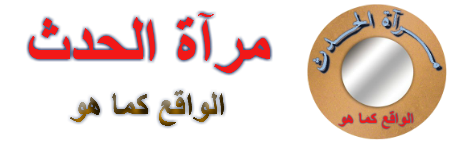 صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
